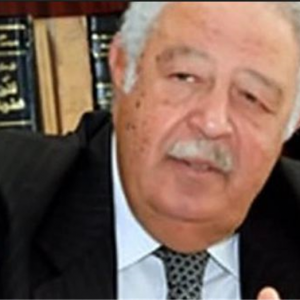وعلْم الله عز وجل ، هو العلم المطلق، ليس نسبيا كعلم البشر ، وعلمه سبحانه لا يأتى ـ كشأن المخلوقين ـ بعد جهل، ومن المحال أن يسبق علمه جهلُ .. فعلمه ـ تعالت حكمته ـ أزلى لا يتقيد بزمان ولا بمكان كما يتقيد علم البشر، ولا يغيب شىء عن إدراكه سبحانه، كما يحصل ذلك لكل آدمى .. فحرص الإنسان على أن لا تفتنه فتنة ما عن ربه ودينه ـ إخبار منه بسلوك سوى يرفعه ويزفه إلى ربه جل شأنه .. لا ليخرجه ـ حاشا لله ـ من الجهل به كما يفعل الناس بين بعضهم وبين بعض، بل ليثبت به لنفسه كمال طاعته فى جواره الداخلى المفترض دوامه بينه وبين ربه .. هذا الجوار نعمة كبرى ميزه بها الخالق عز وجل، ورحب سبحانه بأن يستعمل فيها الإنسان لغته الآدمية أيا كانت ـ على قدر ما تبلغ من التطور والتقدم.
وأكثر من ثلاثة أرباع اللغة الآدمية ـ رموز وإشارات.. تعكس حياة البشر وتصور عواطفهم وآمالهم ومخاوفهم .. لو فقدوها ـ تنهار حياتهم وينهار ما معها من العلاقات والروابط والأصول والعادات والقيم التى بنيت عليها حياتهم.
ونحن نستعمل ذات هذه اللغة فى بناء صلاتنا بالحيوانات القابلة للاستئناس وبالنباتات التى يتاح لنا فرص التعامل معها، أما علاقة البشر بالطبيعة غير الحية وبالحيوانات والنباتات غير القابلة للاستئناس، فعلاقة أحادية من طرف واحد فقط هو الإنسان .. أما غير الإنسان فلا يشارك فى هذه العلاقة ويكفى أن يرضخ ويذعن ويقوم بما يطلبه منه الآدمى، طبقا للنواميس الطبيعية الكونية التى تنقاد لها كل الأشياء غير الحية أو غير الواعية التى تملأ الكون الهائل الذى لا يعدو كوكب الأرض أن يكون مجرد ذرة متضائلة فيه!.. ونحن لا نعرف عن طبيعة هذه النواميس إلا قليلا جدًّا برغم ألوف السنين التى مرت على وجودنا الآدمى.. ومعرفة هذا القليل القليل ـ قد مكنت الآدميين ومكنت معهم الأحياء من حيوان ونبات ـ من البقاء والتطور! .. وهو ما يلفت نظرنا إلى كفاءة الحياة وقلة حاجتها إلى المعرفة الواعية، واعتمادها الفطرى الآلى على ما تزودها به الطبيعة غير الحية ـ اعتماداً يكاد أن يكون كليا نشهده فى أنفسنا وفى داخلنا ـ كما نشهده فى بلايين الأحياء من حولنا!
ويبدو أن الجزء الذى يسعى فينا إلى محاولة إزاحة ما يستطيع إزاحته من ستار المجهول الكثيف الذى يغطى داخلنا وخارجنا ـ هو فقط ما نسميه «الذات الواعية! .. وهو يفعل ذلك بدافع قوى من الفضول والجرأة المتوفرة لدى بعض الناس، فإذا نجح فى شىء من ذلك أو أحس بأنه نجح ـ امتلأ شعوراً بتفوقه وتميزه على أمثاله .. هذا التميز يثير فى البداية استرابة أمثاله فيما وصل إليه، ثم يصدقونه وينقلون ويتناقلون عنه على قدر ما أتيح لهم من الفهم، ثم يفارق هذا جدته ويُنسى فى الغالب صاحبه، ولا يفكر الأتباع فى فحصه ومراجعة صحته ـ إلى أن يعلو بينهم صوت ما بضرورة تقويمه أو مخالفته!
يتكرر هذا كله ويتطور ـ إيجابا وسلبا ـ بقدر مايكون لدى الآدميين من الاستعدادات وتبعًا لما يحيط بهم أو يقابلهم من الظروف .. يحدث هذا دون مفارقة أثر الاختلاف الطبيعى بين أنواع المعرفة .. فالمعرفة المتصلة اتصالا وثيقا بخبرات الحياة العملية المستمرة المتوالية ـ تتعرض عادة للتغيير والتعديل والتطوير، بسرعة أكبر مما تتعرض له المعرفة الأكثر ثباتا المتصلة بالقيم والدين والأخلاق والجماليات، فهذه المعارف الأخيرة تكون عادة أطول عمرًا وأكثر ثباتًا وأقل تعرضًا للتغيير المفاجئ، ومع ذلك لا تسلم من تأثير توالى الأيام والليالى وتبدل ظروف الزمان والمكان وحلول الأجيال الجديدة محل القديمة!
وللخبرات العملية الجارية معتقداتها وإن كانت بطبيعتها ترحب بالتحسن والتعديل والتطوير، ولكن قد تتجمد هذه المعتقدات فى الجماعات المصابة بخمول قديم أو مزمن، وفى هذه الحالة تحبس هذه المعتقدات أصحابها فيما معها من قديم، بينما يتجه معظم الناس فى الجماعات النشطة إلى التغيير فى الأداء وتطويره، ولا ينقطع عنها التعديل والاستحداث فى هذا الجانب أو ذاك .. ويشعرها هذا الانتباه بقيمتها فى عين نفسها وعيون الآخرين .. ولكن قلما تحس مثل هذه الجماعات بأية هزة فى معتقداتها الدينية أو القيمية أو الأخلاقية .. لأنها تبدو باقية فى أسسها ونظمها ومحاولاتها المعهودة لا يتأثر جوهرها ـ عند أتباعها ـ بالتطور والتقدم الحاصلين فى الخبرات العملية .. ومعظم الناس يتمسكون بما كان يتمسك به آباؤهم من القيم والدين والمبادئ التى ترجع إلى مئات وأحيانا إلى ألوف السنين!