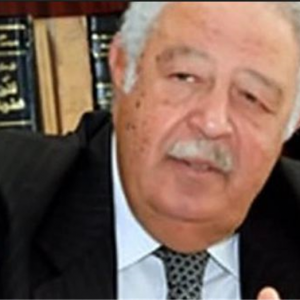يرى الدكتور محمد مندور بحق، أن فقرة الأستاذ العقاد السالف بيانها، قد تضمنت الكثير من مبادئ الرمزية فى الشعر الحديث، فهو يطلب إلى التشبيه بأن يطبع فى وجدان سامعه وفكره صورة واضحة مما انطبع فى نفس الشاعر، وهو لا يرى أن التشبيه قد ابتدع لرسم الأشكال والألوان، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس، وبذلك يمكن القول بأن جماعة «الديوان» كانوا من رواد الرمزية التى نمت بعد ذلك، وازدهرت عند شعراء أبوللو بنوع خاص، بل أسرف بعضهم فيها إلى حد رأينا معه رائدها عبد الرحمن شكرى يتنكر لها وينتقدها بشدة فى مقال بمجلة أبوللو فى نقد الرمزية وافتعالها، حيث نراه يقتبس كلمة لشاعر الإغريق الغنائى الكبير « بندار » وهى قوله للشعراء: «ابذروا البذر باليد لا بالزنبيل ثم يعلق على هذا القول المتزن بقوله: «يعنى أن الزارع إذا رمى بذرًا كثيرًا فى مكان واحد، فإن النبات الذى ينبت قد يقتل بعضه بعضًا وكذلك الشاعر إذا أدخل الصور الشعرية بعضها فى بعض فى جملة واحدة أفسد بعضها بعضًا».
ويرى الدكتور مندور أن الكسب الجديد الباقى فى نقد العقاد لشوقى وفى دعوته التجديدية، كان فى نظرته وزميليه إلى التشبيه ووظيفته الشعرية، وهى النظرة التى نقلت التشبيه من مجال الحواس الخارجية إلى داخل النفس البشرية، إذا طلبوا أن يكون الهدف من التشبيه هو نقل الأثر النفسى للمشبه من وجدان الشاعر إلى وجدان القارئ أو السامع، وبذلك فتحوا الباب أمام التعبير الرمزى.
الحركة الفنية
وبالرغم من أن معركة العقاد مع شوقى كانت لها فيما يقول الدكتور مندور وغيره أسباب ودوافع نفسية وأخلاقية عميقة لتزلف شوقى فيما أخذه عليه للعظماء ومداهنته لهم وتمسحه بأبوابهم، كمديحه المغالى فيه لبطرس غالى، وصيرورته شاعر الأمير لما كان يتملق به الخديوى، على تفصيل لا يتسع له المقام، مما دفع العقاد إلى كثير من الإسراف والقسوة، فإن هناك معالم للمقاييس التى إتخذها العقاد فى نقد شوقى وشعره.
وأول ما يستحق النظر، هو الأساس الفلسفى العام الذى بنى عليه العقاد نقده لشعر شوقى والشعر التقليدى بصفة عامة، ويرتد هذا الإساس إلى إيمان العقاد بالحرية ثم الحرية ثم الحرية، وإيمانه أيضًا بالفردية أو الأصالة الفردية، ومن هذين الركازين نبع الأساس الفلسفى لنظرية العقاد فى الشعر الغنائى، بأن يكون تعبيرًا عن الوجدان الفردى الحر للشاعر وقد تجلى هذان الركازان لفلسفة الأستاذ العقاد العامة فى الحياة والأدب، فى عدد من مقالاته الثقافية العامة والنقدية الأدبية الخاصة على السواء، كمقالاته مثلاً فى مجموعة
«مطالعات فى الكتب والحياة»، «عبقرية الجمال»، «الحرية والفنون الجميلة»، وما أبداه فى مقدمة المجموعة عن «الجمال والحرية»، وعن «فلسفة الجمال والحب» إلى غير ذلك مما تناولناه سلفًا فى المجلد الأول من مدينة العقاد ( ص 141 / 201 فى مدينة العقاد / 1).
على أن الأستاذ العقاد أوضح بجلاء أن الحرية ليست الفوضى، وإنما هى نظام، وعن ذلك كتب لمجلة الهلال الشهرية مقالاً عن «الفن والحرية»، مما قاله فيه إن «الفن الجميل مدرسة النظام، كما هو مدرسة الحرية، وأن الخروج على النظام هو الفوضى وليس الحرية».
والأستاذ العقاد انطلاقًا من هذا النظر، لا يعترف بالشاعر الذى لا تطالعنا شخصيته ومزاجه الخاص ونظريته إلى الحياة وفلسفته فيها من خلال شعره، ويرى الدكتور مندور فى كتابه «النقد والنقاد المعاصرون» أن هذه النظرة تتفق إلى حد كبير مع طبيعة الشعر الغنائى وجوهره، وإن عاد فانتقد تجنى العقاد على شوقى عندما أنكر عليه كل أصاله وتجديد، واتهمه بالسير فى الدروب المطروقة البالية، والصدور من القوالب التقليدية المتحجرة، بينما لشوقى صور شعرية قوية، وموسيقاه رنانة، ولا يمكن إنكار طاقته الشعرية الفذة.
وحدة القصيدة !
من الأصول الأساسية التى بنى عليها الأستاذ العقاد نظريته فى الشعر التى أبداها فى كتاب الديوان، مبدأ «وحدة القصيدة»، أى «الوحدة العضوية»، وفى ذلك يقول العقاد بكتاب الديوان:
«إن القصيدة ينبغى أن تكون عملاً فنيًا يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن الموسيقى بأنغامه بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها. فالقصيدة الشعرية كالجسم الحى يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغنى عنه غيره فى موضعه إلاَّ كما تغنى الأذن عن العين أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة».
بهذا قوض العقاد النظرة التقليدية إلى «بيت القصيد» أى البيت الذى يكون أمير شعر الشاعر، فإنما قيمة البيت فى موقعه من كلٍّ أكبر، من معمار القصيدة الكلى، وإلاَّ جاء نتوءًا ونشازًا يلفت النظر إلى ذاته، وينسى أنه جزء من كل، يقوم بقيامه ويسقط بسقوطه.
وهذا المبدأ هو الذى اتخذه العقاد فى الديوان معولاً من المعاول التى استخدمها لتحطيم شعر شوقى، فأخذ يقدم ويؤخر فى أبيات رثائه لمصطفى كامل، مقررًا أن القصيدة لا تفقد شيئًا بهذا التقديم والتأخير نتيجة لانعدام الوحدة العضوية فيها، ويرى الدكتور مندور أن الشيخ حسين المرصفى كان أسبق إلى هذه الدعوة، فجاء فى مقالٍ له يقرظ فيه إحدى قصائد البارودى:
«ثم اجمعها وانظر جمال السياق وحسن النسق، فإنك لا تجد بيتًا يصح أن يقدم أو يؤخر، ولا بيتين يمكن أن يكون بينهما ثالث».
rattia2@hotmail.com
www. ragai2009.com